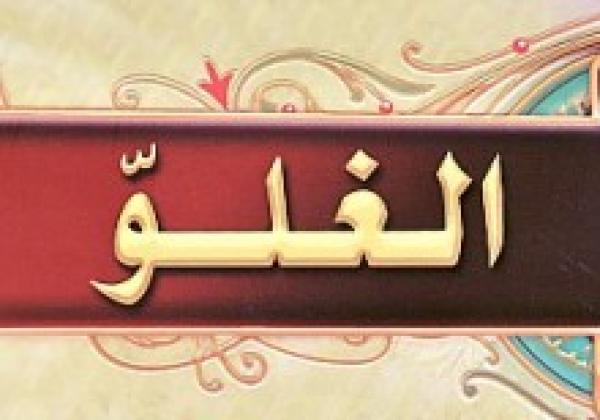
ثالثا:البيئة وأحوال المجتمع:
إن غربة الإسلام فى ديار المسلمين تعمل عملها فى نفسية المسلم الملتزم المتمسك بتعاليم دينه فى هذا العصر، وخصوصا فى مراحل الشباب.
ذلك أنه يرى المنكر يُستعلن، والفساد يستشرى، والباطل يتبجح، والعلمانية تتحدث بملء فيها، والماركسية تدعو إلى نفسها بلا خجل، والصليبية تخطط وتعمل بلا وجل، وأجهزة الإعلام تشيع الفاحشة، وتنشر السوء. يرى النساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، ويرى الخمر تشرب جهارا، وأندية الفساد تجعل الليل نهارا. يرى المتاجرة بالغرائز فى أشدها، من أدب مكشوف، وأغانٍ خليعة، وصور فاجرة، وأفلام داعرة، مسلسلات ومسرحيات... إلخ.. كلها تصب فى نهر الإغراء بالفسوق والعصيان، وتعوق دون الوصول إلى فهم الإسلام الصحيح.
إن تعطيل شرع الله فى الأرض، وما نتج عنه من انتشار وشيوع الشر والفساد وراء الوقوع فى آفة الغلو والتطرف، كرد فعل مضاد لذلك، على نحو ما وقع لشريحة من شباب أمتنا الإسلامية فى هذا العصر، بعدما رأى شرع الله معطلا، والشر والفساد على أشده، فحمله حبه لدينه، وحرصه على مرضاة ربه، وجرته حماسته، أن ينبرى للعمل وحده دون أن يكون معه من يوجهه أو يرشده، فتردى فى آفة الغلو أو التطرف.
إن الله تعالى توعد المسلمين بعقوبات شديدة إن انتشرت بينهم المعاصى بغير نكير، فقال سبحانه وتعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (الأنعام:123) وقال جل جلاله: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا) (الإسراء:16)، والمترفون فى كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال والخدم والراحة، فينعمون بالدعة والراحة وبالسيادة، حتى تترهل نفوسهم وتأسن، وترتع فى الفسق والمجانة، وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات، وتَلِغ فى الأعراض والحرمات، وهم إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا فى الأرض فسادًا، ونشروا الفاحشة فى الأمة وأشاعوها، وأرخصوا القيم العليا التى لا تعيش الشعوب إلا بها ولها؛ ومن ثَمَّ تتحلل الأمة وتسترخى، وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها، فتهلك وتطوى صفحتها.
وأنبه إلى أمر قد يخفى على البعض ألا وهو أن المطلوب منا شرعًا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وإن لم نُؤمر بإزالة المنكر، فقد لا يستطيع المسلم إزالة المنكر ولكن لا يسعه ترك إنكاره، وهذا حجة على المتخاذلين ممن ترك هذه الشعيرة بدعوى أنه لن يغير المنكر.
رابعًا: اتباع المتشابهات وترك المحكمات:
إن اتباع المتشابهات من النصوص، وترك المحكمات البينات، هذا لا يصدر من راسخ فى العلم، إنما هو شأن الذين فى قلوبهم زيغ (فيتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) (آل عمران:7).
والمقصود بالمتشابه: ما كان محتمل المعنى، وغير منضبط المدلول، وبالمحكم: البين المعنى، الواضح الدلالة، المحدد المفهوم.
إن المغالى أو المتطرف فى هذا العصر، تجده يعتمد على المتشابهات فى تحديد كثير من المفاهيم الكبيرة التى رتب عليها نتائج خطيرة، بل بالغة الخطر، فى الحكم على الأفراد والجماعات، وتقويم، وتكييف العلاقة بهم من حيث الولاء والبراء، والحب والعداء، واعتبارهم مؤمنين يُتولون، أو كفارا يقاتَلون.
وهذه السطحية فى الفهم، والتسرع فى الحكم، وخطف الأحكام من النصوص خطفا دون تأمل ولا مقارنة _ نتيجة لترك المحكمات البينات، واتباع المتشابهات المحتملات _ هى التى جعلت طائفة الخوارج قديما تسقط فى ورطة التكفير لمن عداهم من المسلمين.
فإذا لم يحسن الشباب الفهم من القرآن والسنة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقفوا طويلا عندها دارسين فاحصين، متأملين متفقهين، جامعين بين أولها وآخرها، وموفقين بين مثبتها ونافيها، ومقرنين بين مطلقها ومقيدها، وخاصها وعامها، مؤمنين بها جميعها، محسنين الظن بها كلها_ محكمها ومتشابهها _ إن لم يفعلوا ذلك فما أسرع ما تضل راحلتهم، ويعمى عليهم طريقهم، وتضيع منهم غايتهم، فيشرقون مرة ويغربون أخرى على غير بصيرة، ويخبطون خبطا عشوائيا فى ليال مظلمة.
وهذا هو الذى وقع فيه دعاة الغلو والتطرف قديما وحديثا، وقد أشار المعصوم صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فيما رواه (عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).
خامسًا: التلقى عن الجاهلين مع خلو الساحة من العلماء أصحاب الرسالة والخبرة:
وقد تكون لدى بعض الشباب الرغبة فى تحصيل العلم، ولا يعرف على يد من يتلقى هذا العلم، فيسوقه قدره إلى من لا بصيرة عنده، ولا دراية، إلى من يعلمه بطريقة تلقائية عفوية، يقوم على أمرها كل غيور متحمس، دونما انطلاق من فقه عليم، أو منهج مدروس، ظنا منه أنه يقدم الدعوة الإسلامية بأحسن مقال، أملا فى الدخول فى زمرة من قال الله تعالى فيهم: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (فصلت:33).
غير أن هذه العفوية والتلقائية، لم تنضج فهمًا للدعوة الإسلامية كما ينبغى، ولم تؤت ثمارها كما يراد لها.. وما ذلك إلا لافتقاد الأصول التى يجب أن تبنى عليها دعوة الإسلام، والفقه الذى يجب أن يسعى على متنه كل داعية همام يبشر بهذه الدعوة.
لهذا يجب على من تعين عليه التصدى لأمر الدعوة، أن يجتهد فى الأخذ عن الأئمة الذين أخذوا بأسبابها، وسعوا لاكتساب فنها، وتشربوا بفقهها، حتى يكون ذا مهارة ودراية قبل أن يدعو عن هواية.
وقد يكون خلو الساحة الدعوية من علماء أصحاب رسالة، وممن ينادون بالوسطية، والذين يضبطون الفكر والتصور بل والسلوك، هو السبب فى الوقوع فى آفة الغلو والتطرف، ولا سيما إذا كانت هناك حماسة، أو قوة إيمان وعاطفة تدفع إلى الدعوة إلى الإسلام. والتمكين له فى الأرض، على نحو ما وقع لشباب الصحوة الإسلامية فى هذا العصر، وبعدما فقدوا الثقة بأكثر المحترفين من رجال العلم، وخاصة المقربين من الحكام منهم، فهم عندهم فى موضع الاتهام، لأنهم يمالئون الحاكم رغم علمهم بأنه على باطل.
فالمسلمون تحركهم فتوى من عالم مخلص وتوقفهم كذلك، وقد تعجز الأسلحة أن تفعل ما يفعله عالم مؤمن؛ لذا يجب على الساسة إظهار احترام العلماء الربانيين، واتّباع ما يقولونه ولو خالفهم فى بعض الأحيان.
وعلى العلماء احترام ما يحملونه من علم شريف.. ولا أقصد هنا أن يكون العالم تبعًا للعامة يفتى على ما يشتهون، ولكن لابد من الصدع بالحق.
وعلى العامة احترام العلماء وإعزارهم، وعلى العلماء القيام بواجبهم، وليحذر المتتبع لزلات العلماء من غضب الله فهم أولياؤه، قال تعالى: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (يونس:62).
وفى المقابل شاهد الشباب انكماش العلماء، وغيابهم عن الساحة الدعوية إيثارا للسلامة، والعافية، فتقدمت شريحة الشباب بلا روية لحمل الراية، واعتمدوا على أنفسهم فى فقه الأحوال، واستنباط الأمور، وقد أتيت بعض الدعوات والحركات من هذا الباب، فكان الوقوع فى آفة التطرف والغلو.
سادسًا: الاشتغال بالمعارك الجانبية
عن القضايا الكبرى:
إن من جملة أبناء الأمة من يشتغل بكثير من المسائل الجزئية والأمور الفرعية، عن قضايا الأمة المتعلقة بكينونتها وهويتها ومصيرها، فنرى كثيرا منهم يقيم الدنيا ويقعدها من أجل حلق اللحية أو الأخذ منها أو إسبال الثياب، أو تحريك الأصبع فى التشهد، أو اقتناء الصور الفوتوغرافية أو نحو ذلك من المسائل التى طال فيها الجدل، وكثر فيها القيل والقال.
هذا فى الوقت الذى تزحف فيه العلمانية اللادينية، وتنتشر الماركسية الإلحادية، وترسخ الصهيونية أقدامها، وتكيد الصليبية كيدها، وتعمل الفرق المنشقة عملها فى جسم الأمة الكبرى، وتتعرض الأقطار الإسلامية العريقة فى آسيا وأفريقيا لغارات تنصيرية جديدة يراد بها محو شخصيتها التاريخية وسلخها من ذاتيتها الإسلامية، وفى نفس الوقت يذبح المسلمون فى أنحاء متفرقة من الأرض، ويضطِهد الدعاة الصادقون إلى الإسلام فى بقاع شتى.
سابعًا: الإسراف فى التحريم
والتباس المفاهيم:
إن من أسباب الوقوع فى آفة الغلو أو التطرف، وجود شريحة من الشباب يميلون دائما إلى التضييق والتشديد والإسراف فى القول بالتحريم، ويوسعون دائرة المحرمات، مع أن النهج الدعوى القائم على الكتاب والسنة الصحيحة وفعل السلف الصالح، يحذر من ذلك أيما تحذير.
وحسبنا قول الله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (النحل:116).
يقول المفسرون: «ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعى، أو حلل شيئًا مما حرم اللّه أو حرم شيئًا مما أباح اللّه بمجرد رأيه وتشهيه، ثم توعد على ذلك فقال: إن الذين يفترون على اللّه الكذب لا يفلحون (أى فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ أما فى الدنيا فمتاع قليل، وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليم).
والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا لا يطلقون الحرام إلا على ما علم تحريمه جزما، أما ما لا يجزم بتحريمه فيعبرون عنه بهذا التعبير: نكره هذا، أو لا نراه، وهكذا من مثل هذه العبارات، ولا يصرحون بالتحريم، أما المائلون إلى الغلو، فهم يسارعون إلى التحريم دون تحفظ، بدافع التورع والاحتياط، إن أحسنا الظن، أو بدوافع أخرى، يعلم الله حقيقتها.
فإذا كان فى الفقه رأيان: أحدهما يقول بالإباحة والآخر يقول بالكراهة، أخذوا بالكراهة، وإن كان أحدهما بالكراهة، والآخر بالتحريم، جنحوا إلى التحريم.
وإذا كان هناك رأيان: أحدهما ميسر، والآخر متشدد، فهم دائما مع التشديد، مع التضييق، هم دائما مع شدائد ابن عمر، ولم يقفوا يوما مع رخص ابن عباس، وكثيرا ما يكون ذلك لجهلهم بالوجهة الأخرى، التى تحمل الترخيص والتيسير.
ومثال القضايا التى دائما يقيمون الدنيا ويقعدونها من أجلها: تقصير الثوب إطلاق اللحية، الشرب جالسا، لبس ثياب بعينها. ومثل هذه القضايا المختلف فيها، والتى تسع الدعوة الإسلامية فيها الناس جميعا فى كل زمان ومكان، لأن الإسلام دين عالمى، جاء للناس جميعا.
وقد أدى هذا الغبش فى فهم الإسلام، وعدم وضوح الرؤية لأصول شريعته، ومقاصد رسالته، إلى التباس كثير من المفاهيم الإسلامية، واضطرابها فى أذهان الشباب أو فهمها على غير وجهها.
ومنها: مفاهيم مهمة يلزم تحديدها وتوضيحها، لما يترتب عليها من آثار بالغة الخطورة فى الحكم على الآخرين وتقويمهم، وتكييف العلاقة بهم، وذلك مثل مفاهيم الإيمان والإسلام، والكفر والشرك، والنفاق والجاهلية ونحوها.
إن قوما لم يتذوقوا اللغة ولم يدركوا أسرارها، خلطوا فى هذه المفاهيم بين الحقيقة والمجاز، فاختلطت عليهم الأمور، والتبست عليهم السبل، واضطربت الموازين. إنهم لم يفرقوا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وبين الإسلام الكامل ومجرد الإسلام. ولم يميزوا بين الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وكفر المعصية. ولا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا بين نفاق العقيدة ونفاق العمل، وجعلوا جاهلية الخلق والسلوك كجاهلية العقيدة سواء.
ويوضح العلامة ابن حجر رأى السلف وغيرهم من الفرق فى مثل قضية الإيمان والكفر هذه قائلا: «فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط فى كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتى والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط والكرامية قالوا هو نطق فقط والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف إنهم جعلوا الأعمال شرطا فى صحته والسلف جعلوها شرطا فى كماله وهذا كله بالنظر إلى ما عند الله تعالى، أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر أجريت عليه الأحكام فى الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا أن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته، وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا الفاسق لا مؤمن ولا كافر».
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنفاق كالكفر، نفاق دون نفاق، ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر».
ويبن رأيه فى تكفير المعين قائلا: «...إنى من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علمت أنه قامت عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافرا تارة، وفاسقا أخرى، وعاصيا أخرى. وإنى أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية وما زال السلف يتنازعون فى كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد بكفر، ولا بفسق، ولا معصية».
فالفرق كبير وشاسع، وشتان بين المؤمن والكافر، ومجتمع الإيمان ومجتمع الكفر، والذى بينهما هو الذى بين الحق والباطل، وبين الطيب والخبيث، والهدى والضلال، والخير والشر.
ذاك مشرك كافر، ومجتمع شركى كفرى، تخطف الريح أفراده، وترمى بهم فى مكان سحيق، يتمرغون فى تراب الكفر والتيه، ويتخوضون فى مستنقعات العمى والضلال الآسنة.
ذاك إنسان لا يقوم على أمر حكيم، ومجتمع لا يسير إلى الله على طريقه المستقيم، بينما المؤمن الذى يعيش فى مجتمع الإيمان والذى يؤمن بالله ربا وإلها، ويعبده حق عبادته، ويطبق منهاجه وطريقه المرسوم له، وإن زل قدم البعض، أو تعثر، أو تاه، أو انحرف عن الاستقامة.
شتان بين من يؤمن وبين من لا يؤمن.. بين من يؤمن ويخطئ، ومن يكفر وينحرف.. بين من يخطئ ويستغفر.. وبين من يخطئ ولا يستغفر وبين من يذنب فيتوب، وبين من يذنب ويصر على ذنبه.
فهل يستويان مثلا؟ (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) (القلم:35).
(وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسِىءُ قَلِيلاً مَا تَتَذَكَّرُونَ) (غافر:58).
فهذه إجابة الله تعالى على هذا السؤال.
ومن ثم لا يجوز تكفير أهل القبلة بمطلق الذنوب إلا بالاستحلال أو الجحود.
أ. د. مجدى عبد الغفار حبيب» رئيس لجنة الدعوة بالجمعية الشرعية الأستاذ بجامعة الأزهر«
المصدر:مجلة التبيان
ابحث


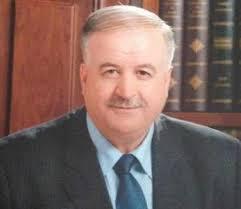








أضف تعليقاً